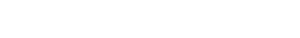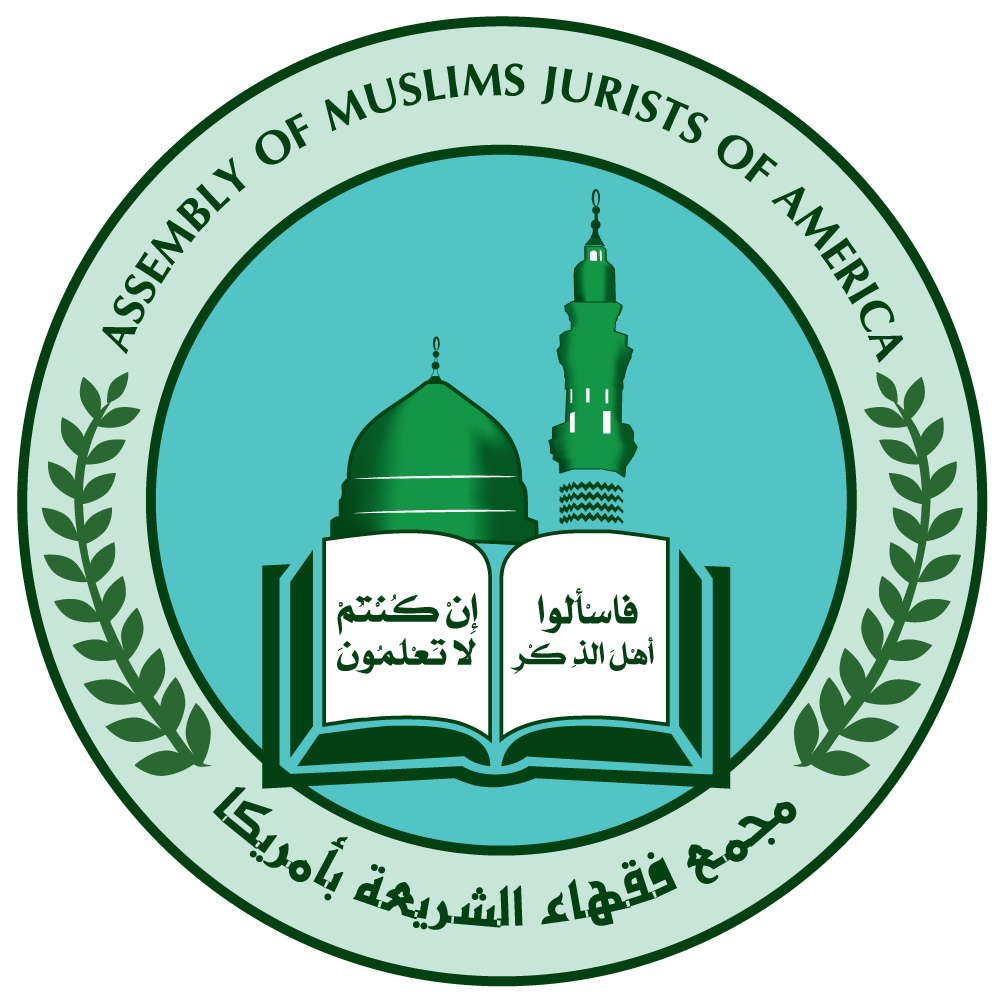AMJA 20th Annual Imams’ Conference – 2024 – Fiqh Responses to Challenges Facing Muslim Families in the West AR
Download as pdf
توصيات مؤتمر الأئمة العشرين
معالجة فقهية لتحديات الأسرة المسلمة في الغرب
مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
قواعد عامة
-
- تقوم أحكام الأسرة على عدة قيم أساسية تشمل: التراضي والمودة والرحمة، والعدل والفضل: تحقيقا للعدل وترغيبا في الفضل، والمسئولية المتبادلة بين الزوجين، والتكامل بينهما لتحقيق التوازن، وأن يكون ذلك كله بالمعروف
- الأصل ثبات الأحكام الشرعية، وأنها لا تتغير بتغير الزمان والمكان، مثل وجوب الواجبات، وتحريم المحرمات، وسائر المقدرات
- تتغير الفتاوى المبنية على الأعراف والعوائد التي تؤثر على مناطات الحكم لتغير هذه الأحوال، على أن يكون لتغير الفتوى مقتضى شرعي. كوجود سبب حادث، أو زوال عارض، أو تغير الوسائل، أو ظهور خطأ علمي ونحوه، فحكم الله لا يتغير لمجرد تغير الزمان والمكان، وإنما لكونهما أوعية لما يحدث فيهما من طوارئ تعرض إلى أعيان الوقائع، فتتغير الفتوى فيها.
- العادة محكمة، وهي ما اعتَادَه أغلب الناس أو طائفة منهم، وساروا عليه، من قول أو فعل أو ترك، ويشترط لاعتباره أن يكون مطردا أو غالبا، وألا يُخالِف حكما شرعيا، وأن يكون العُرْف المتعلِّق بالتصرُّف موجودًا عند إنشائه. وتتمثل مجالات تحكيمها في: فهم إطلاقات الشرع. وتفسير أقوال الناس، ومعاملاتهم، وتقييدها، وتصحيحها. وتغير الأحكام المبنية على العادات لتغير مناطاتها.
- العُرْف غير الإجماع لأنه غير ثابت؛ ولا يُشتَرط فيه اتِّفاق كلِّ الناس عليه؛ ولا توفُّر مَرتَبَة الاجتِهاد الشرعي لأهله.
- العرف العام في أمريكا معتبر ما لم يخالف الشرع، وهو محكم في أحكام الاسرة كغيرها من المعاملات، فالفتوى تتغير في أحكام الأسرة بتغير الأحوال والعوائد، وما يقتضيه ذلك من إعادة النظر في تحقيق مناطات بعض الأحكام الشرعية بما يراعي الواقع ويحقق العدل والاستقرار الأسري، ومن ذلك استئناس المحكم المسلم بما تقرره المحاكم من مقدار النفقة في الحضانة، ومراعاة ما تستدعيه ظروف الحياة المعاصرة بخصوص تحديد أوقات الزيارة للوالد غير الحاضن، وكذلك ما تعارف الناس عليه في صفة اللباس ما لم تتضمن تشبها بخصوصية دينية لغير المسلمين.
- ينبغي لمن يتصدى للفتوى في باب من الأبواب معرفة مقاصد الشريعة وقواعدها، والنظريات الفقهية المتعلقة بمحل البحث، مع العناية باستقصاء الأدلة التفصيلية لتجنب مخالفة النصوص الشرعية، ولا بد من توجيه الفتوى إلى تحقيق المصلحة العامة مع مراعاة الضوابط الشرعية والرجوع إلى الراسخين من أهل العلم والمجامع الفقهية في القضايا الكبرى التي تتطلب اجتهادًا جماعيًا.
المحور الأول: مرحلة ما قبل الزَّواج
حول التزويج قبل التثبت من حُسن الإسلام أو التوبة
- يَثبُت عقد الإسلام بالإقرار المُجمل بالتوحيد والرسالة، إقراراً التِزامياً، يُقصَد به الإجابة إلى الإيمان والدخول في الإسلام، والبراءة من كل دين يخالفه.
- ثبوت عقد الإسلام كاف للتزويج، ولكن ينبغي التثبت من حُسن إسلام مريد الزواج من المسلمين الجدد، من الرجال والنساء جميعاً، وهم يُنصحون كذلك بالتثبت من حُسن إسلام الراغبين في الزواج منهم وصدق رغبتهم، وهو آكد في حق النساء، للاستيثاق من مناسبة الزوج، ومكافأته لكمال دين المخطوبة، وذلك أَوْلى من الاستفسار عن طبائعه وقدرته المالية والصحية ونحو ذلك ممَّا يزيد من فُرص التوافق.
- لا يقدح في صحة الزواج أن يكون سبب إسلام الخاطب علمه بأن الكافر لا يجوز له الزواج بمسلمة، فالمسلمة لا تصلح فراشا شرعيا لغير المسلم بحال.
عضل الأولياء وآليات معالجته
- العضل هو امتناع الوليّ من تزويج موليته بغير مسوغ شرعي؛ ومنه امتناعه من تزويجها بكفء رضيته، ولا خلاف في تحريم العضل لأنَّه ظلم يتنافى مع مقصود الولاية في النِّكاح وهو النظر والإحسان، وإذا ثبت العضل فمن فروض الكفاية أن يتدخل أهل الحل والعقد ووجهاء الجالية لمنع الوليّ من العضل.
- إذا أصر الولي الأقرب على العضل سقط حقّه في الولاية، وتنتقل الولاية إلى السلطان، أو من يقوم مقامه خارج بلاد الإسلام، وهو من فوضت إليه الجالية المسلمة أمور النكاح والفرقة في المراكز الإسلامية. ويقوم غياب الولي الأقرب وعدم رده على الاتصالات والمكاتبات مقام العضل، ويسري عليه حكمه، إذا تحقق من يتولى العقد لها من ذلك.
الكفاءة في باب الزواج
- الكفاءة في النكاح هي التماثل بين الزوجين في أمور يترتب على مراعاتها التوافق بينهما.
- الكفاءة المعتبرة للزوم العقد هي الكفاءة في الدين والخلق، وعدم وجود عيب منفر يتضرر منه الطرف الصحيح، وهي حق خاص بالمرأة والولي.
- اتفق أهل العلم على صحة نكاح ولد الزنا، والراجح أن مرد الكفاية إلى الدين والخلق وقت الزواج.
نكاح غير المسلمات في الغرب
العفة المشترطة في الزواج بالكتابيات: مدلولها وتطبيقاتها
- لا يجوز الزواج بغير العفيفات من المؤمنات أو من الكتابيات، والعفة ألا تكون المرأة على علاقة غير مشروعة عند الزواج بالمسلم، ولا يقدح في عفتها ما فعلت قبل توبتها عند التحقق من التوبة، ومن تابت من معصية المخادنة وجب استبراؤها بحيضة.
- العقد على الكتابية العفيفة صحيح، والزواج بها مشروع مع الكراهة، نظرا للمخاطر التي تتهدد الناشئة عند الطلاق واستئثار الأم بالحضانة.
حول التواصل بين الراغبين في الزواج وحدوده
- لا بأس بالاستعانة بمواقع التعارف والزواج الموثوقة لمن استطاع الباءة وعزم على الزواج، ويحسن بالمرأة أن تخبر بذلك أهلها قبل الشروع فيه.
- إذا وضعت المرأة صورتها فلا يجوز أن تتبرج بزينة، ولا حرج في وضع الأسماء المستعارة عند التحرج من وضع الاسم الحقيقي، مع بيان الحقيقة عند التعارف.
- الأصل في العلاقة بين الجنسين هو الغض من الأبصار إلا لخطبة، وأن يكون الحديث بالمعروف بين المتخاطبين على مواقع التواصل بغرض الزواج، وضابط ذلك أن كل ما جاز قوله أو فعله بسبب عقد الزواج من مباشرة أو مغازلة ونحوه فلا يجوز قبله.
- لا يُرخَّص في استدامة التواصل بين المخطوبين بالصوت والصورة على وسائل التواصل الاجتماعي إلا لحاجة معتبرة، على أن يكون ذلك بعلم الاهل وإذنهم، لا سيما إذا أمنا من اطلاع الغير عليهما.
- لا يجب على أيّ من الطرفين الإفصاح عن زلاته الماضية للطرف الآخر، وينبغي الإفصاح عما وراء ذلك من العيوب من كلِّ مذمومٍ شرعًا أو عُرفًا، ويتأكد فيما كان منها موجبا للفسخ، مما لا تطاق استدامة الحياة معه، أو يؤثر فيها تأثيرًا بينًا كالجنون والجذام والبرص والأمراض الجنسية، والأمراض النفسية الحادة، ونحوه.
المحور الثاني: مرحلة الزواج
اختلاف الأزمنة والأمكنة والاحوال، وأثره على القوامة الشرعية
- القوامة ولاية شرعية يُفوَّض بموجبها الزوج في تدبير شؤون الأسرة والقيام بما يصلحها، والمقصود الشرعي بها الإصلاح والرعاية وليس البغي والاستطالة، ولها سببان وهبي وكسبي (بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) ومن أهم ضوابطها: أداء الزوج لواجباته، والعدل، والحكمة في استخدام القوامة.
- يُحتفظ للرجل القائم بواجبه في النفقة بحقوقه الأساسية، مثل الطاعة في المتعة، وعدم الخروج من بيته إلا بإذنه، وعدم الإذن في بيته لمن يكره، على أن يُنصح الرجال بعدم التصلب في استعمال هذه الحقوق، ولاسيما إذا شاركت المرأة في النفقة.
- الأصل أن أصحاب الولايات الخاصة والعامة يُطاعون في موارد الاجتهاد، فينبغي للزوجة طاعة زوجها في المسائل الاجتهادية فيما لا يشق عليها ولا يضر بها، وهي طاعة في العمل وليست في الاعتقاد، فلها أن تعتقد ما شاءت ممَّا ترجح لديها: اجتهادا أو تقليدًا سائغًا، ولكن في العمل ينبغي أن يطاع الزوج في اجتهاده، لما تمهد من جواز العمل بالمرجوح والمفضول في هذه المسائل رعاية لمصلحة الاجتماع والائتلاف، ولا ينبغي للزوج التصلب في القضايا الاجتهادية فإن المحافظة على كيان الأسرة أولى من إقامة هذه الفروع.
- إن تعلق الأمر بعبادات الزوجة المحضة – الواجبة أو المستحبة – من حيث الحكم أو الكيفية، وكان اختيارها لا يؤثِّر على الزوج، فلا يتضمن تضييعاً لحقوقه، ولا إساءة له: فلا يجب عليها طاعته على خلاف ما تتدين به.
- يشدد على أهمية العدل والإنصاف في التعامل مع الزوجات عامة لا سيما مع ربات البيوت، والتأكيد على حقوقهن في حالة الطلاق، والابتعاد عن التعسف في استعمال حق القوامة.
- الحقوق تقابل الواجبات، وللنساء مثل الذي عليهن بالمعروف. ومن واجبات الزوج النفقة على زوجته، فإن أعسر بالنفقة، وأبى السعي لكفاية نفسه وأهله، أو منعها من غير إعسار، فليس له منعها من الخروج للتكسب وقضاء حوائجها، ولجهة التحكيم أن تأذن لها بالاستدانة على حساب الزوج، ولها سعة في الامتناع عن فراشه، وللمرأة أن تستصلحه بما يصلحه من رفق وتودد، أو امتناع، وتنصح المرأة الصالحة بالصبر على زوجها المعسر، فإن لم تصبر أو نفد صبرها، فلها طلب التطليق للضرر.
- ولا يقتضي الإعسار بالنفقة إسقاط الحق العام في التواصي بالمعروف متى ظهر تركه، والتناهي عن المنكر متى ظهر فعله.
- في ظل شيوع الفتن ورقة الدين في الغرب ينبغي تجنب الغلو في رؤيتنا للقوامة، والتعاطي معها غلوًا يؤدي إلى تقويض دعائم البيت، ويأتي بنيانه من القواعد، وقد يترك العاقل بعض الحق استبقاء لبقيته!
العلاقة مع الأحماء: إسكانا ونفقة وقوامة
- للزوجة على زوجها الحق في توفير مسكن آمنٍ لها، تتمتع فيه بالخصوصية مع زوجها، ومن ذلك استقلالها بمرافق البيت كالمطبخ، وبيت الخلاء، ونحوه.
- لا ينبغي لأي من الزوجين أن يُسكن مع زوجه في بيت الزوجية أحدًا من أقاربه وإن كان مكلفا بالإنفاق عليه، إلا إذا كان ذلك عن تراضٍ منهما وتشاور، محافظة على حقهما في الخصوصية في بيت الزوجية.
- ينبغي للزوجة تفهم ظروف زوجها العاجز عن توفير مسكن مستقل للضعفة من والديه أو أولاده. فإن هذا من حسن عشرتها له، ومن أقصر الطرق إلى قلبه! كما لا ينبغي للزوجة الصالحة التضجر من نفقة زوجها على أهله وبره بهم.
- إنفاق الرجل على من أقام معه من أحمائه من مكارم الأخلاق والمروءات، وليس من قبيل الفرائض والواجبات.
عمل المرأة وتبعاته الأسرية والمالية
- يُنصح الأزواج عند عمل المرأة بإعادة توزيع الأعباء المنزلية: المالية وغيرها بما يحقق العدل والتوازن، ومراعاة الفضل في الحياة الزوجية، ولا يسوغ إلزام الرجل بالتنازل عن حقوقه لتمكين المرأة من العمل من أجل الترفيه أو الادخار الشخصي، كما لا يسوغ إلزام المرأة بالمشاركة في النفقة مع تحميلها أعباء تربية الأولاد وتدبير الأمور المنزلية.
- لا حرج في أن يتفق الزوجان بينهما بالمعروف على مشاركة الزوجة العاملة بجزء من نفقة البيت مقابل ما فوتته بعملها من رعاية بيت الزوجية، والعبء الذي أضافته بنفقاتها المهنية على موازنة البيت.
- لا حرج أن يتفق الزوجان قبل الزواج أو بعده في حدود الخيارات المشروعة، على ما يمنع الشقاق بينهما من التراتيب المالية والأسرية.
- حول منع الإنجاب قبل التثبت من استقرار العلاقة الزوجية
- المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والتماس الولد الصالح بالنكاح أحد المقاصد الرئيسة في النكاح.
- لا حرج في التحكم المؤقت في الإنجاب لمصلحة شرعية معتبرة، على أن يكون ذلك عن تراض من الزوجين وتشاور، لأن الحق في الولد مشترك لهما. بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر، وأن تكون الوسيلة مشروعة، وألا يكون فيها عدوان على حمل قائم قد تجاوز مدة الرخصة في إسقاط الحمل، ولا حرج في التراضي على تأخير الإنجاب عند ظهور بوادر شقاق.
- لا ينبغي الاستئصال الدائم للقدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة، وهو ما يعرف بالإعقام أو التعقيم ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية. مع ملاحظة أن كثيراً مما كان يُعدّ إعقاماً دائماً لم يعد كذلك.
حول المساكنة الشرعية:
- المساكنة الشرعية يُراد بها حق كل من الزوجين في أن يضمهما مسكن مشترك، يوفر لهما الخصوصية، ويستشعران فيه نعمة الحياة الزوجية!
- المساكنة الشرعية من الحقوق والواجبات الشرعية المشتركة بين الزوجين، فهي حق لكل منهما، وواجب على كل منهما، تُستوفى من كليهما على النحو الذي شرعه الله ورسوله، يُطالب بها من قعَدَ عنها ويلزَم بها، ويخاصم فيها من سلبت منه، ويطلبها صلحاً أو تحكيماً أو قضاء!
- لا تكون المساكنة شرعية بين الذكر والأنثى التي ليست من محارمه إلا إذا ربط بينهما رباط الزوجية، وكل تداعٍ إلى المساكنة خارج هذا الإطار فهو دعوة منكرة إلى الزنا الصريح، وإمعانٌ في إفساد منظومة الأسرة، والمجتمع: دينياً وحقوقياً وأخلاقياً.
- إذا استجدت ظروف تحول دون هذه المساكنة الشرعية لأسباب طارئة كفقد الزوج، وغيابه، وسجنه، ونحوه، فقد عالجتها الشريعة ومدونات الأحوال الشخصية بما يرفع الضرر عمَّن لم تستطع عليه صبرا، كالحق في الطلاق أو الفسخ ونحوه.
حول أحكام الأولاد غير الشرعيين (ثبوت المحرمية)
- النسب: لحمة شرعية بين الأب وولده، تنتقل من السلف إلى الخلف، وحفظه من مقاصد الشريعة، ومن التدابير الشرعية لحفظ الأنساب: تحريم الزنا وقطع الذريعة إليه، وتشريع الأحكام الخاصة بالعِدَّة، وتحريم كَتْمِ ما في الأرحام، والتشوف إلى إثبات النسب، وتحريم جحده.
- للشرع تشوف إلى إثبات النسب، فيثبته بأضعف الأدلة، ولا ينفيه إلا بأقواها.
- الولد للفراش، إذا مضى على عقد الزواج الصحيح أقل مدة الحمل، وهي ستة أشهر (ويرجع فيما هو أدنى من ذلك إلى أهل الخبرة) ولم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين.
- ماء الزنا هدرٌ لا يثبت به نسبٌ، ولا تنتشر به المحرمية في الخلوة والسفر والزواج ونحوه، وإن انتشرت به الحرمة.
- يثبت نسب ولد الزنى إذا ادَّعاه الزاني، ولم ينازع في ذلك، ولم تكن المرأة فراشًا لأحد، درءًا للمخاطر التي تتهدد الطفل إذا نشأ مجهولَ النسب في هذه المجتمعات.
- إذا ألحق ولد الزنا بمن استلحقه ثبتت له أحكام الأولاد الصلبيين الشرعيين من ثبوت المحرمية والإرث وغيره.
- إذا لم يستلحق ولد الزنا ثبت نسبه لأمه، لأن الأمومة علاقة جبلية، ويجرى التوارث بينها وبينه بمقتضى هذه الأمومة الفطرية، وفي انتشار المحرمية من جهتها خلاف، وانتشارها بالرضاعة متفق عليه.
حق الكد والسعاية
- حق الكدّ والسعاية هو حق الزوجة في ثروة زوجها إذا شاركته في تنميتها ببذل المال، أو بالسعي والعمل، أو بكليهما معاً. ويرجع أصل ذلك إلى أدلَّة الشَّريعة الإسلامية الواردة في حِفظ الحُقوق، والمُقرِّرَة لاستقلالية ذمّة المرأة الماليّة، فضلا عن قضاء الخليفة الرّاشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحق زوجةٍ في مالِ زوجها الذي نمَّياه معاً قبل تقسيم تركته.
- حقّ المرأة في الكدّ والسّعاية مُتعلّق بأعمال الزوجين ومعاملاتهما المالية دون غيرها، إن اشتركا فيها بالمال والعمل أو بأحدهما على النّحو المذكور آنفا، فأعمال المرأة المنزلية لا تدخل في حقّ الكدّ والسّعاية.
- ولا يُغني التزام الزّوج بالنّفقة على زوجته عن حقّها في كدّها وسعايتها في عملٍ كَوَّن ثروتهما على النحو المذكور، لأن نفقة الزّوج على زوجته بحسب يساره وإعساره حقّ واجب عليه فلا علاقة له بحقها في الكد والسعاية، ولا يستطيع أن يحتج بإنفاقه عليها لإبطال حقها في الكد والسعاية.
- وحقّ الكدّ والسّعاية للزوجة لا يُقدَّر بنصف ثروة الزوج أو ثلثها، وإنما يُقدّر بقدر مالِ الزوجة المُضاف إلى مال زوجها وأرباحه، وأجرة سعيها وكدِّها معه، ويمكن للزوجة المطالبة به، أو المسامحة فيه، أو في جزء منه.
- لا يتعلق أخذ الزّوجة حقّ كدّها وسعايتها من ثروة زوجها بانتهاء الزوجية بوفاة أو طلاق، وإنما هو حقّ للمرأة حال حياة زوجها وبقاء زوجتيهما، لها أن تأخذه أو تتسامح فيه؛ إذ الأصل فيه أنه مال للزوجة، جعلته على اسم زوجها لاتحاد معايشهما ومصالحهما الأسرية.
- يُستوفَى حقّ المرأة في الكدِّ والسعاية من تركة زوجها المُتوفَّى مع قضاء ديونه، وقبل إنفاذ الوصايا أو تقسيم التركة.
- يجمل بالزوج أن يبذل لزوجته حقها في الكدّ والسّعاية في حياته بنفسه، لتجعله في ذمتها المالية الخاصّة، منعاً للتشاحن أو التجاحد بين الورثة بعد الممات، مع التأكيد على أن عدم توثيق هذا الحق لا يعني ضياعه.
- حقّ الكدّ والسّعاية ليس حقًّا خاصًّا بالزوجة في مال زوجها، بل يمتد حق الكد والسعاية ليشمل ما يستحقه كل من ساهم بماله أو بجهده في تنمية أعمال أحدٍ وثروته، كالأولاد ونحوه.
- لا ينبغي تحويل حق الكد والسعاية وما يعنيه من حفظ الحُقوق وتعزيز العدالة داخل الأسرة إلى شعارات عُنصرية، وإجراءات مُتحيّزة، تُزكي من الاستقطاب والنِّديّة بين الزَّوجين، وتَعرِض الزَّواج في صورة ماديّة مُنفِّرة لا مودة فيها أو سَكَن؛ الأمر الذي قد يفضي إلى عزوف كثيرٌ من الشَّباب عن الزَّواج وتكوين الأُسر.
المحور الثالث: مشكلات في الحياة الزوجية
الاضطهاد الأسري: صوره وأحكامه
- الاضطهاد الأسري سوء معاملة شخص لشخص آخر تربطه به علاقة وثيقة، مثل العلاقة بين الزوجين، أو بين الأولاد، أو الإخوة ونحوه. ويتخذ أشكالاً عدة منها: الإيذاء البدني واللفظي والاجتماعي والمالي والنفسي والصحي.
- ومن أسبابه التهاجر بين الزوجين بلا مسوغ شرعي، وسوء التربية، وضغوطات الحياة اليومية، والانحرافات الأخلاقية، كتعاطي المسكرات والمخدرات، والمشكلات الاقتصادية من بطالة ونحوها.
- والأدلة قاطعة في رفض الاضطهاد الأسري بجميع أشكاله، المادية والمعنوية، ويتفاوت حكمه بين التحريم والكراهة الشديدة باختلاف الصور.
- لا يجوز للمرأة أن تمتنع عن فراش زوجها بغير عذرٍ شرعيّ، فإن فعلت أثمت، ولا ينبغي للزوج إكراه زوجته على الجماع، لأن الإكراه في هذه الحالة عادةً ما يلحِقُ أذىً جسديًا ونفسيًا بالزوجة ويزيد الشقاق ويخالف القوانين المحلية ويعرض الزوج للمساءلة الجنائية ويسيء إلى سمعة الجالية.
الضرر في الزواج
- الضرر في العلاقات الزوجية يتمثَّل في عدم التزام أحد الزوجين بحقوق الآخر، أو إساءة استخدام الحقوق، أو غير ذلك ممَّا يسبِّب أذى مادياً أو نفسياً معتبراً.
- إذا تعرَّضت الزوجة للضرر، ولم يجد التحكيم في الإصلاح بينهما، فلها الحق في طلب التطليق للضرر. كما يمكنها اشتراط تفويضها بالطلاق في عقد الزواج، عند تضمينها له في الإيجاب، ولا يُنصح به إلا عند الخوف من وقوعها في العنت بغياب الزوج أو تعنته.
- يُوصى باللجوء إلى التحكيم لحل الخلافات الزوجية، وإعطاء المحكمين الشرعيين صلاحية التفريق عند ظهور الضرر واستحالة الإصلاح.
معالجة ظاهرة النشوز في العلاقات الزوجية
- النشوز هو حالة من التمرد، والترفع عن القيام بالحقوق التي فرضتها الشريعة للزوجين، وقد يكون من جانب الزوج، أو من جانب الزوجة، وهو محرَّم في كلا الجانبين.
- تتدرج الشريعة في معالجة ظاهرة النشوز على التَّرتيب التالي:
- الصبر على الزوجة ووعظها بالحكمة والموعظة الحسنة.
- الهجر في المضجع: كإجراء تقويمي، مع الحذر من التمادي فيه؛ لتغير الزمان، ورقة الدين، وضعف الإيمان، واختلاط المفاهيم.
- الضرب الخفيف غير المبرح: ويستخدم كآخر حل مع مراعاة القيود الشرعية والأخلاقية. فالأصل هو الاستغناء عن التأديب الجسديّ بالكلية، وهذا ما كان عليه صاحبُ الخُلُق العظيم ﷺ الذي لم يضرب بيده غلاما ولا امرأة قط، ولا يجوز الضرب إذا لم يكن مرجو الثمرة، ويتأكد ذلك في المجتمعات التي تجرمه، لما يفضي إليه من مسائلات قانونية وقضائية.
- جمهور الفقهاء على أن نشوز الزوجة البين يسقط نفقتها وسكناها، ومن أظهر صوره الامتناع عن الفراش وترك بيت الزوجية، وترجع إليها النفقة والسكنى برجوعها عن نشوزها.
- للزوجة في حالة نشوز الزوج السعي إلى الإصلاح، أو طلب التحكيم أو التدخل القضائي إذا استمر الزوج في نشوزه، ووقع الضرر عليها منه، مثل الهجر في المضجع بلا مسوغ، أو الامتناع عن النفقة، أو منعها من زيارة أهلها.
- يترك الحكم في النشوز للمراكز الإسلامية والهيئات الشرعيّة والمؤهلين من أهل العلم.
الخيانة الزوجية وسبل التعامل معها
- الثقة هي ركيزة أساسية في الزواج، والالتزام والإخلاص عوامل حيوية في استقرار العلاقة الزوجية، بينما تتسبب الخيانة بسائر درجاتها في تدمير هذه الثقة، وتؤدي إلى عواقب خطيرة تشمل الأسرة بأكملها والمجتمع من بعدها.
- الخيانة الزوجية في الاصطلاح العرفي المعاصر هي: عدم الإخلاص بين الزوجين، والانخراط في علاقات جنسية أو مقدماتها مع طرف آخر.
- ومن أسبابها ضعف الوازع الديني، وعدم مُراعاة الحقوق الزوجية، وطول التهاجر أو الغياب، والمشكلات الصحية: البدنية أو العقلية المزمنة، والإدمان، وعدم الالتزام بالضوابط الشرعية في العلاقات العائلية، والاستغراق مع وسائل التواصل الاجتماعي.
- لمواجهة آثار الخيانة، توصي الشريعة بالتوبة النصوح، وينصح بدعم الطرفين عبر الإرشاد الفردي والزوجي لإعادة بناء الثقة أو تحقيق التعافي العاطفي، متى كان ذلك ممكنًا. فإذا تعذّر الإصلاح واستحال استمرار العلاقة، توفّر الشريعة خيارات مثل الطلاق للرجل، أو الفسخ بحكم القاضي للمرأة، أو التفريق للضرر. ولا يترتب على زنا أحد الزوجين الانحلال التلقائي لعقدة النكاح، وإنما يعطي الزوجة المتضررة الحق في طلب التطليق للضرر، وللزوج المتضرر عضلها لتفتدي نفسها بالخلع.
- لا أثر لزنا الزوجة على لحوق نسب الولد إلا إذا نفاه الزوج باللِّعان، لأن الولد للفراش وللعاهر الحجر.
الطلاق المدني ومدى نفاذه شرعًا
- الأصل أن الطلاق لمن أخذ بالساق، فهو تصرف قولي يناط بالزوج باعتباره الذي بيده عقدة النكاح، ثم للقاضي المسلم أو من يقوم مقامه خارج ديار الإسلام، في الأحوال التي قررت فيها الشريعة ذلك، كالتطليق للضرر، أو الشقاق والنزاع، أو الإعسار، أو الغيبة، أو السجن والأسر ونحوه.
- الطلاق المدني هو حل العقدة المدنية للنكاح، من خلال القضاء الوضعي.
- ينفذ الطلاق المدني شرعًا إذا وقع برضا الزوج من غير إكراه معتبر، مع إقراره بنية الطلاق، ويقتصر دور المحاكم المدنية على مجرد التوثيق.
- إذا صدر الطلاق المدني رغمًا عن الزوج كان مرد الأمر إلى المركز الإسلامي أو الهيئة الشرعية المؤهلة لذلك، ويكون تطليقها نافذا بعد استيفاء الإجراءات الشرعية المتّبعة في التقاضي.
التعويض عن الطلاق
- الأصل في الطلاق الحظر إلا لمسوغ شرعي، في الأرجح من أقوال العلماء، وفعله بغير مسوغ شرعي يعد تعسفًا في استعمال الحق يأثم صاحبه، ولكنه لا يطالب بالتعويض فوق ما يقرره الشرع من مؤخر الصداق، ونفقة العدة، والمتعة، لعسر إثبات الأسباب التي أفضت إليه، ولأن هذه الحقوق الشرعية، لا سيما المتعة، تغطي الضرر الناتج عن الطلاق، وتحقق العدالة.
المتعة
- المتعة مال يبذله الزوج لامرأته عند حل عقدة النكاح بطلاق أو ما في معناه، جبرًا لخاطرها المنكسر بالطلاق. وتستحقها المطلقة قبل الدخول والخلوة الصحيحة إذا لم يُسمَّ لها مهر، فإن كان قد سُمّي لها مهر، فلها نصفه، ومتعة مستحبّة، وتجب هذه المتعة لكلِّ مطلقةٍ مدخول بها ولم تكن المفارقة بسبب من قِبَلها.
- وتُقدّر المتعة حسب يسر المطلق، وحال المطلقة، وفقًا لما يقضي به العرف والعادة، مع مراعاة ظروف الطلاق، ومدة الزوجية، والاستحقاقات الأخرى، كنفقات الأولاد وأجرة الحاضنة ونحوه. وهدفها في حالة المدخول بها تعويض المرأة عن مصيبة الطلاق وحفظ كرامتها وصيانتها عن الحاجة والابتذال، خاصة تلك التي فرغت نفسها لخدمة الأسرة، وضحت بحياتها المهنية أو جزء منها لأجل استقرارها الأسري، مع ضرورة التوافق بين علماء الأقليات المسلمة على تحقيق هذه المبادئ من خلال لجان التحكيم والأئمة.
ولا حرج في التراضي ابتداء على أن يكون مؤخر الصداق نسبة من مدخرات الزوج الناشئة بعد الزواج.
- لا يجوز اتخاذ المتعة ذريعة لتسويغ ما تقضي به القوانين الوضعية من المقاسمة في جميع الممتلكات التي نشأت بعد الزواج.
التوارث عند اختلاف الملة
اختلاف الدين مانع من الميراث، والغالب في التوريث السائد عند غير المسلمين في الغرب أنه يجري مجرى الوصية.
- باب الوصية أوسع من باب الميراث، فلا حرج في قبول المسلم وصية غير المسلم له بجزء من التركة، وله أن يقبل عند عدم وجود الوصية من غير المسلم ما تطيب له به نفوس ورثته لجريانه مجرى الهدية.
- تجوز الوصية لغير المسلم إيصاءً وقبولًا شريطة ألا تزيد على الثلث، لأن الكفر لا ينافي أهلية التمليك والتملّك، لا سيما إذا كانت على وجه الصلة لقرابة ونحوها، ولا حرج في أن يوصى لجهة عامة ينتفع بها المسلمون وغير المسلمين.
- يجب على المسلم المغترب أن يوصي بتقسيم أمواله بعد وفاته على وفاق الشريعة، وينصح بالرجوع إلى من يثق فيه من المرجعيات الشرعية.
المحور الرابع: نوازل الشذوذ الجنسي في العلاقات الأسرية
مسؤولية الوالدين:
- يسأل الآباء عن تربية أولادهم على المبادئ الإسلامية والقيم الأخلاقية. ولا يسألون بعد ذلك عن اختيارات أولادهم لمسار الشذوذ بعد بلوغهم، شريطة أن يكون الآباء قد أدّوا واجبهم في التربية والنصيحة.
- يُنصح الآباء بالتمييز بين ما كان مرده من الشذوذ إلى المعاناة والاضطرابات النفسية، وما كان مرده إلى محض اتباع الهوى وعدم الاكتراث بالشرائع، فإن هذا التمييز يساعد الآباء في تحديد كيفية التعامل معهم، مع تقديم التعاطف والتوجيه لمن يواجه صعوبات نفسية، ووضع حدود زاجرة إذا كانت هناك أفعال تتعارض مع الإسلام.
- تجنب طرد من أصيب بفتنة الشذوذ من البيوت ما أمكن، منعا لمزيد من الفتنة في دينهم، مع وضع حدود زاجرة تحول دون قبول السلوك المنحرف، وتأكيد الحرص على حماية باقي أفراد الأسرة، وتقديم مصلحتهم عند التعارض، تطبيقا للقاعدة النبوية: “لا ضرر ولا ضرار” وفرعها “لا يزال الضرر بمثله”.
تقديم الدعم والإرشاد الصحيح:
- يُوصى الآباء بالبحث عن دعم ومساعدة متخصصة تتوافق مع المبادئ الدينية والخلقية، من خلال اللجوء إلى دعاة ومستشارين وأطباء نفسيين يدعمون المنظور الإسلامي للتعامل مع هذه الحالات. مع التأكيد على تجنب الخيارات المتطرفة التي تدعم الأفكار المؤكدة للهويات غير المشروعة أو التي تستخدم أساليب قاسية وغير علمية في التعامل معها.
الزواج بين المثليين والمتحولين جنسياً
- يجب على الآباء إرشاد أبنائهم إلى أن الزواج في الإسلام هو عقد شرعي بين رجل وامرأة فقط. أما الزواج بين أفراد من نفس الجنس فهو باطل شرعًا، ولا يفيد حلًا ولا إباحة، بل قد يخرج بالفعل المحرم من دائرة المعصية إلى دائرة الكفر إذا استحلها بعد قيام الحجة.
- يجب إعلام الطرف الآخر في عقد الزواج الشرعي باضطراب الهوية الجنسيّة ليكون على دراية بالأمر، ويقرر مدى استعداده للتعامل معه.